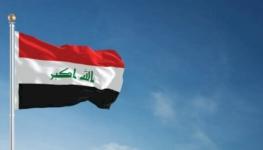سالم بن مسلم الدوسري المهري
أصوات تتكرر، تشكو أوضاعًا تكاد تكون طبيعية داخل دائرة تداعيات معترك الحياة، التي لابد أن تكون مُعقدة غير التي ألفناها قبل 50 عامًا أو حتى أقل من ذلك، فنحن جزء من نظام السوق شبه الرأس مالي، من حيث البنية التنظيمية لحركة السوق.
إنِّه عالم متفاقم ومُعقد بقدر حجم طموحات كل من يُواجهه، وأحسبُ أن علينا جميعًا فعل ذلك. إذ لا تجد من لا يشكو مشقة في إدارة منظومة حياته؛ بل من عدم قدرته على تدبير الأمور بشكل عقلاني، فالأسعار لا تمكِّنه من الوفاء بالتزاماته المعيشية لأسرة لا يتعدى عدد أفرادها 7 إلى 12 شخصًا (في المتوسط). ودائمًا ما نسمع عبارات مُكررة مثل: "لم أعد قادرًا على دفع فواتير الماء والكهرباء لمنزلي القائم على أعمدة تحمل طابقين لا تزيد غرفه عن 10 غرف نوم مع ملاحق الضيافة بكل ما يحتاجه من لوازم الكهرباء مع مكيفات وتوصيلات أخرى"، وأن "تكلفة بنائه كانت خيالية ولا قصور من البنوك ولا يزال راتبي التقاعدي أسيرًا لهذا القرض الذي كان مُغريًا يوم ما، وسعر الوقود يرتفع بجنون وما عدت قادرًا على تحريك سياراتي الثلاث في الشارع".
ثمَّة تجربة وأسئلة مبعثرة لا تغادر ذهني: من المسؤول عن كل هذا؟ وماذا يفعل الموظفون والعاملون الوافدون هنا؟ إنِّهم يمتلكون إرادة أكثر من كافية ليعملوا ليلًا ونهارًا ولم يتعرفوا بعد على الكلل ولا حتى الملل لدقيقة واحدة، يستفزون الجزء الأكثر انتهازية في منطقة اللاوعي لديَّ، لا أترددُ في كيل الانتقادات للمسؤولين، لماذا يسمحون لهم بالعمل في بلدي؟ لكنني أتذكر أولئك الذين شيدوا منزلي الذي حمل حُلمي أن أملك منزل العمر، ثم تأتي مرحلة عُمر أخرى للصيانة وإصلاح الأعطال الطارئة، إنها دوامة الحياة، فلولا هؤلاء لما كان لي منزل أو عثرت على متخصص لإصلاح سياراتي. إنه صراع فكري ثقافي تحت تأثير مشاعر مُتداعية وغير منطقية، إذ إنَّ وجود العمال الوافدين يُصيبني بحالة من التنافر المعرفي، وتتفاقم حالة العجز الفِكري المتجذر في الاتكالية وانتظار الهبات والوظيفة المُريحة.
سؤال انحيازي لأحد التجار: أين أموالكم؟ لابُد أن أحصل على إجابة لا تنحرف عن نمط الانحياز الفِكري الذي أملكه، ولكن ما ذنب التجار الذين يكابدون أمواج الواقع، وهم لا يساهمون في صنع القرار، وليسوا جزءًا أصيلًا من منظومة وضع تشريعات صناعة السوق، بينما سيكون عليهم خلق أغلب الوظائف لمن لا يتمتع بالكفاءة، عدا التفكير في "الراتب والذهاب إلى البيت"، وعلى أغلب القطاع الخاص الأكثر بؤسًا المساهمة في حل أزمة التوظيف لهؤلاء، ومن ثم دفع الكثير من الضرائب من أجل البقاء في نفس الحلقة التي تدور حول نفسها.
التجّار لم يعودوا أثرياء، فقد تلاشت فرص المكاسب السهلة، فالسوق فقدت قوتها الشرائية وهي تحتضن مستهلكًا لا يُقدم على شراء كل شيء، وربما لم يعُد يحتاج شراء أي شيء، مع بروز واقع مفترض لإعادة هندسة الفِكر الاستهلاكي ووضع الأولويات. ومع ذلك يتبنى الجميع قناعة أن الحكومة لا بُد أن تفعل كل شيء، أو أي شيء لحماية حدود الترف، وأنه دون ذلك قليلًا قد ننزلق إلى حدود أكثر فقرًا!
لقد تشّكلت لدينا قناعات واقعية متداعية لمشهد رومانسي مُتخيل على أننا جزء من دولة "هايدروكربونية" كغيرنا، ولا نُجهِد أنفسنا في وضع حسبة لعدد السكان وتكلفة التنمية من بلد كربوني إلى آخر. هل نحن الذين نضع لأنفسنا معايير البؤس مع ما نملكه من عقارات ومركبات فارهة؟ أما الإشكالية- بل قل الأزمة الأعمق- أنه من هنا تبدأ مقولة "الحياة صعبة"!
الأزمة هي أن الحياة ليست صعبة، كما نتخيلها، الحياة هي نحن بمنظومة أفكارنا المرتبطة بمستويات وعينا المتحور حول قراءة المشهد من زاوية عاطفية ورفض التعليمات العقلانية التي تأتينا من الجزء الموضوعي من عقولنا. والحكومة ليست مسؤولة عن كل شيء، لكننا مضطرين لوضعها كحائط مبكى لهمومنا وربما لإخفاقنا في إدراك وإدارة ما يجري من حولنا ضمن هذا العالم غير المنطقي كما نراه. الحياة ليست صعبة، الحياة هي الحقيقة والحقيقة هي نحن، ونحن أحفاد 180 مليار نسمة هلكَت قبلنا.