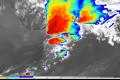عبدالله العليان
يعيش الوطن العربي في ظرفنا الراهن أزمة بنيوية عميقة، يتخوف البعض من أن تعصف بالاندماج الذي يعيشه عالمنا العربي منذ قرون، وهذا يعتبر من المشكلات الخطيرة التي ربما تسهم في التفكيك أو الدخول في الصراعات الداخلية، والواقع أنّ التعددية الثقافية، قيمة عظيمة في الحضارات الإنسانيّة باعتباره صيغة للتعايش والتواصل الحضاري الإنساني من خلال القبول العام بالتعددية الثقافية، سواءً داخل الحضارة الواحدة، أو مع غيرها من الحضارات والثقافات الأخرى، ولذلك يمكننا أن نعتبر بحق أن التنوع ميزة الإنسان على الأرض دون سواه، وهو للإنسان، بل سمح لكل مجموعة بشرية أن تعلّم وتتعلم من الأخرى ضمن ديناميكية التبادل الثقافي. في كتابه (إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر).
ويرى د. حسام الدين علي مجيد "أن التعددية الثقافية هي نظرية وسياسة في التعامل مع التنوع الثقافي، بحيث تستند إلى فكرة التلاحم والتقارب ما بين الجماعات الثقافية في مجتمع ما، وعلى أساس المساواة والعدالة الثقافيتين، والاعتراف رسمياً بكون تلك الجماعات مُتمايزة ثقافياً، ومن ثمّ تطبيق ذلك عملياً من خلال سياساتٍ معينة تميلُ إلى مساعدةِ تلك الجماعات والتعزيز من تَمايُزِ كلٍّ منها ثقافياً. فالتعدّدية الثقافية من حيث كونها نظرية سياسية، هي بمثابة اعتقاد أو ربما فرض يحاول دُعاتهُ سَبْرَ أغوارٍ جديدة تتناول المرجعية الفكرية للدولة - الأمة بالتعديل أو التغيير بما ينسجم وطبيعة التنوّع الثقافي للمجتمع. أمّا من حيث كونها سياسيةـ وهي عادةً ما تُعرَفُ بتسمية سياسة التعدّدية الثقافية فهي من قبيل آليات عملٍ تهدفُ إلى معالجة الحِرمان بشكلٍ عام. وعلى فَرْضِ أنَّ التعددية الثقافية هي نظرية كما يقول د. حسام الدين، فهي ما تزال كذلك فعلاًـ في التعامل مع وضعية التنوّع الثقافي، وهي من ثم أسلوبٌ في معالجة ظاهرة الانبعاث تلك، فسيدفعُ ذلك إلى افتراضٍ آخر مفادهُ: أنَّ عامل التباينات الثقافية هو متغيّر أساسي في إثارة هذه الهويات، فَبِقَدر ما يدفعُ مركز الدولة - الأمة إلى السيطرة على أطرافه، فقد يُثيرُ في الوقت نفسه تفاوتات اجتماعية واقتصادية ما بين الأكثرية المهيمنة والأقليات المتباينة عنها ثقافياً.
وينبغي الإشارة كما يشير الباحث، إلى أن أية هوية ثقافية تقوم بوظيفتين جوهريتين؛ فمن جهة هي تكسب أعضائها حس الانتماء المشترك، بمعنى التضامن، وذلك من خلال توليد الاعتقاد بتماثلهم في الأصول والمعتقدات والموروث الثقافي عموماً. ومن جهة أخرى تعمل الهويّة الثقافية على إبعاد كل من لا ينتمي إليها، وإقصائه عن تلك الجماعة. هاتان الوظيفتان نُطلق عليهما تسمية التباينات الثقافية،على أساس فكرة كون الهوية الثقافية لا تتولد بذاتها، وإنما تتمخض عادةً بفعل التباين والتمايز من "الآخر" الذي يتوطن عين المكان والزمان، بحيث تبرز التباينات في شتّى مكونات الثقافة،وهي:اللغة، والدين، والأصل القومي والإثني، والموطن الجغرافي، ولذلك فهي تتخذ أشكالاً عدة: لغوية، ودينية، وعرقية، وإثنيّة، وقبلية، أي بمعنى تنصب التباينات الثقافية ما بين الجماعات في كلا الجانبين الملموس وغير الملموس للهوية الثقافية، إنّ فكرة فاعلية تأثير التباينات الثقافية في نشوء الدولة عموما كما يشير الباحث، كانت فكرةً في حالِ من التطور التدريجي تاريخياً إذ ابتدأت بالقبيلة والدين في الدول القديمة، وذلك بحكم كونهما الأساس الذي يقوم عليهما التنظيم الاجتماعي، إذ بالرغم من ظهور الدولة، إلا أنّ المركز لم يعمل بدوره على التخلص من هذه التباينات الثقافية، لأنّها ببساطة كانت تجسد الأساس المادي الذي يقوم عليه نموذج الدولة القديمة. وفي ضوء ذلك، يرى ترجيح الفكرة القائلة بكون الدولة هي التي أنشأت الأمّة والهويّة القومية، إذ أنّ تكون الدولة - الأمّة في مسارها التاريخي إنّما نجم أصلاً عن إرادة واعية وتخطيط هادف من لدن المركز في تعامله مع أطراف الدولة، بحيث إنّه قد ساهم في بلورة الوعي القومي والانتماء المشترك، وكانت غاية المركز الرئيسية من ذلك هي الإفلات من قبضة الكنيسة – ذات التوجّه العالمي ـ وولايتها على الأفراد. فمفهوم الدولة - الأمّة أو الدولة الحديثة بذاته مفهوم يشير في ثناياه إلى ذلك الصراع بين مشروع الدولة الدينية العالميّة التوجّه ومشروع الدولة المدنية ذات التوجّه القومي. ومن هنا، كما يرى الباحث، قام ذلك الترابط الوثيق ما بين الدولة - الأمّة والليبرالية. فإبّان القرنين التاسع عشر والعشرين، شهد الغرب اتجاهين رئيسيين: ابتدأ أولهما بإعادة التنظيم شبه الشامل للمجال السياسي، وذلك بالانتقال من كتلة مختلطة ومضطربة من الإمبراطوريات والممالك والدول المدن والحاميات والمستعمرات، والدخول في نظام الدولة - الأمة، بحيث شرعت جميعها في انتهاج سياسات بناء الأمة، مستهدفةً بذلك نشر هوية قومية مشتركة، فضلاً على ثقافة ولغة موحدتين داخل أقاليمها. ويتمثّل ثانيهما في الاستبدال شبه الشامل لكل أشكال الحكم غير الليبرالية بأنظمة حُكم ديمقراطية ليبرالية. ومن الناحية الظاهرية، يبدو أنّ هذين الاتجاهين لا يجمعهما جامع، إلا إنّ حقيقة الأمر هي أنّ هناك ترابطاً جوهرياً ما بين الدولة - الأمّة والديمقراطية الليبرالية. هذا الارتباط الجوهري إنّما يتجسد في كون الدول- الأمم تجسد الوحدات الملائمة لتطبيق الطروحات السياسية الليبرالية. فقد انتهج الليبراليون حزمة من السياسيات لبناء الأمة الواحدة تتمثل في: سياسية الهجرة الداخلية والتوطين وسياسة التلاعب بحدود وسلطات الوحدات الفرعية الداخلية، فضلاً عن سياسة اللغة الرسمية. فهذه السياسات تستهدف إحداث تغييرات جذرية في البناءين المادي والفكري للأقليات المتباينة ثقافياً عن الأكثرية، حيث تبتغي السياستان الأولى والثانية إحداث تغييرات في الوجود المادي للأقليات المستهدفة، بالشكل الذي يقود إلى إضعاف قدراتها المادية، ولا سيما على صعيدي الثقل الديمغرافي والانتشار الإقليمي، الأمر الذي يوفر الأرضية الملائمة للسياسة الثالثة في تحقيق هدفها، والمتمثل في الاستيعاب الثقافي، أي الولوج إلى داخل البناء الثقافي واللغوي للأقليّة، ثم تغييره كلياً حتى يتحقق بذلك الاستيعاب الكلي، وذلك لإدراك دعاة الليبرالية بأنّ استمرارية تنوّع هذا البناء ثقافياً وتباينه داخلياً ستؤدي إلى جعله مصدر تهديد جد كبير للبناء السياسي وأساسه الفكري معاً. ومن ّثم، فإنّ العمل بتلك الأسس، مثل المساواة في فرص العمل والمشاركة السياسية والحرية الفردية، تقتضي جميعاً وجود مجتمع متماسك ثقافياً ومتضامن اجتماعياً، بحيث تتلاشى فيه التباينات الثقافية، أو على الأقل يتم تحييدها وإبقاؤها في منأى عن المجال العام للدولة.