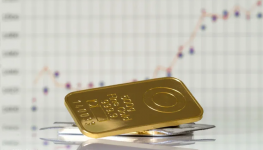![]()
عبدالله خميس
إلى أطفال زهران القاسمي (هنيئًا لكم قريتكم الجميلة)
ليست لديّ ذكريات سعيدة تعود لفترة طفولتي، ولكني أثق أنّ طفولتي كانت (سعيدة) كأي طفل آخر عاش في زماني ومكاني. سرّ سعادتنا كأطفال هو في براءتنا، وهي كلمة ملطفة لمفهومَيّ الغفلة والجهل.. نعم، فما يجعلنا أبرياء هو أننا نغفل ما يدور حولنا؛ أننا جاهلون به. جاهلون بمعاناة آبائنا لتوفير لقمة عيشنا، غافلون عن المعارك الدائرة في المجتمع حول المصالح والمنافع المختلفة، ومع هذه (البراءة) فلا تحمل ذاكرتي لحظات سعيدة، لا لأنني لم أعشها، ولكن لأننا لا ندرك أننا سعداء إلا بعد أن تنقضي اللحظة التي كنا نحس فيها بالإشباع والرضا. ربما كانت الطفولة أبعد من أن تستطيع ذاكرتي الواهنة استعادتها، فلا أتذكر إلا شذرات قليلة. على أية حال فإنّ لديّ ذكريات سيئة من فترة مراهقتي، كون المراهقة هي فترة عنف عاطفي/ وجداني وصدام مع المجتمع المحيط. لا أريد أن أتذكر فترات سيئة، وكم أتمنى لو أنّ ذاكرتي تسعفني بتذكر شيء سعيد من طفولتي. ورغم فقد الذاكرة هذا، فقد استيقظت اليوم بحلم مليء بالحنين إلى الطفولة.
رأيت فيما يرى النائم منطقة مليئة بضواحي النخيل المقسمة لمُلاك مختلفين. المنطقة تقع خلف بيت طفولتي بمزرعة واحدة. تقود إلى تقاطع الضواحي؛ هذه سكة ضيقة هي بالأصل ساقية الفلج، وعند تقاطع المزارع توجد "تحويلة" يتم عندها تحويل مجرى الفلج إلى هذه المزرعة أو تلك. في تلك الناحية يوجد بيت طيني كان يبدو لنا مريبا، تسكنه عجوز مخيفة (رغم أنّ أمي مازالت تذكر هذه المرأة بكل خير وتترحم عليها وعلى طيبتها، إلا أنّها كانت تخيفنا نحن الأطفال). لا يحدث في الحلم الذي رأيته شيء سوى أنّه يعيدني لتلك المنطقة. أنا متأكد أنّ لها اسما لكني ما عدتُ أذكره، فكل عشرة أمتار وكل مزرعة كان لها اسم في كل مكان بأرض عمان وفي جميع ولايات عمان الداخل. في الحلم كنتُ شخصًا بالغًا يتلصص على ذلك المكان، السكك الصغيرة جدًا المحاذية لسواقي الفلج، والفلج ذاته. كنت مثل الدكتور إيزاك في فيلم (الفراولات البرية) لبيرجمان: عجوز يرى طفولته ويرى نفسه صغيرًا يلعب مع أقرانه. في الحلم، كان الحنين يعتصرني، وقد استيقظت متخيلا نفسي أكتب مقالة عن هذا الحنين، لكنني سرعان ما عدت للنوم! الآن، أحاول استعادة ذلك الحلم لأفهم معنى الحنين الذي كان يعبق به. لا أجد شيئا محددا أحن إليه الآن. لا أتذكر حادثة سعيدة محددة. بل على العكس، أتذكر أشياء غير إيجابية في ذلك المكان. أتذكر أننا نسبح في الفلج غافلين لاهين ثم نتفاجأ بعصا رجل بغيض تلشطنا على ظهورنا لأننا "نِسْبَح سبّوحة القرّة" (نسبح كالضفدعة)! كان شخصا بغيضا لن أغفر له. مجرد عجوز من الحارة لا يحب سباحة الأطفال ويعطي نفسه حق ضرب أي واحد منهم بعصاه. من كنتَ أيها البائس حتى يسمح لك الأهالي بذلك؛ أن "تؤدب" أطفالهم نيابة عنهم؟! أتذكر في ذاك الفلج العقارب المندسة بين "الخلاقين" التي كانوا يحشون بها أطراف "اللجالة" لسد مجرى الفلج وتحويله لوجهة أخرى. أتذكر العجوز المخيفة والبيت الطيني الذي يوحي أن الجن تستوطنه.
ثمة شيء آخر كان يحدث في ذلك المكان؛ ملتقى المَزارع المملوك كل منها لفرد مختلف. إنّها طقوس كشف الضر (نسيت اسم الطقس بالعامية). طقس تذويب معدن (لعله الألمنيوم أو القصدير) بالنار الساخنة جدا ثم سكب المعدن المذاب في إناء به ماء. وهنا كنا نغنى لحظة سكب المعدن المذاب في الماء حتى يتشكل المصهور على صورةٍ ما: "يا صويرة تصوّري. كان حمامة تصوري. كان فراشة تصوّري.. كان (ما أعرف من) تصوّري.. إلخ".. كان البصّار (وهو بالنسبة لي حاليا ليس سوى محتال بائس آخر تماما كالعجوز صاحب الخيزرانة)، كان ينظر لقطعة المعدن الذائبة ليرى بأي شكل تصورت، فيقول مثلا "سنورة" أو "كلب"، وهذا يعني أنّ الضر الذي أصاب الشخص المريض ناتج عن ذلك الحيوان. أو ربما عن جني تهيأ بشاكلة ذلك الحيوان، وكل حيوان وله علاجه وقرابينه. كنت كطفل مدعو دومًا للمشاركة في طقس كشف الضر، لأنني توأم (كان لي أخ توأم توفي وعمره سنة واحدة). كنت مطلوبًا لأنّ التوأم (مبارك). كنت مطلوبًا أيضًا لعلاج عيون المصابين بالرمد. حيث أبول (بوصفي طفلا مباركا) في فنجان، ثم يتم قطر عين المريض ببولي المقدس!
ذكرى وحيدة غير سيئة تربطني بملتقى المزارع هذا ذي العقارب في وسط فلجه والمحفوف بالعجوز الشريرة. شجرتا مانجو كانت تتساقط ثمارهما عندما تنضج. كنت أحب المرور بذاك الطريق وأسعى أن أكون أول المارين لعلّي أحصل على ثمرة مانجو غير خربانة وليس فيها دود قد سقطت ولم يسبقني إليها أحد. كان هذا نادرا ما يحدث، فما أجده غالبا هو ثمار فاسدة. إذا كانت هذه أسعد ذكرياتي في هذا المكان، فلماذا يعود إليّ في الحلم بوصفه مكانا أحن إليه؟ حسنا، في حقيقة الأمر فإن لدي رغبة أن أسير في هذا المكان مرة أخرى ولو لمرة واحدة في حياتي. لم يعد أهلي يسكنون ذات المنطقة. بيتنا القديم لايزال قائمًا لكنه آيل للسقوط، وقد يقع في أية لحظة على رؤوس الباكستانيين الذين يستأجرونه حاليا بثلاثين ريالا عمانيا لا غير! الجيران مددوا بيوتهم وسوّروا مزارعهم. ولا أظن ساقية الفلج ما تزال موجودة، ولا أعلم هل مازال الفلج يجري أم قد أصابه المحل. أذهب إلى قريتي مرة كل شهرين ونصف في المتوسط، لليلتين لا ثالث لهما. وأنا أقود للبلدة أقول لنفسي: "هذه المرة سأفعلها.. سأذهب عند البيت الطيني، وسأمشي في نفس الطريق لمرة أخيرة لأرى كيف أصبح". لكني في كل زيارة للبلدة لا أغادر بيت عائلتي الجديد الذي يقع بعيدا عن تلك المزرعة ذات البيت الطيني الذي تسكنه عجوز يخافها الأطفال لكن أمي ما زالت تدعو لها بالرحمة والغفران.
لا أتذكر أحداثا سعيدة في ذلك المكان، ولا أتذكر حدثا سيئا لافتا للنظر. فحتى ضرب العجوز لنا بخيزرانته عندما نسبح في الفلج لا يترك لديّ ذكرى مؤلمة (ورغم أنّي لن أسامحه على فعلته كموقف عقليّ مني بوصفي شخصًا بالغاً ناضجًا، فإنّي أيضا لا أحمل حقدا طفوليا نحوه). لا ذكريات حزينة ولا سعيدة. ومع ذلك فرغبتي قائمة لأسير في ذلك المكان ولو لمرة واحدة أخيرة. أخاف القيام بالخطوة لأني شبه متأكد أنّ المكان كله لم يعد موجودًا. لابد أنّ معظم النخيل قد مات. ولعلّ الفلج قد اندثر بكل عقاربه. والبيت الطيني قد تمت إزالته. ولم تعد المزارع متداخلة وفيها سكك ترابية ضيقة يتنقل عبرها الناس بين أجزاء الحلّة، إذ لابد أن المزارع قد تم تسويرها بجدران الأسمنت التي ألغت الوصال بين الأهالي. ألهذا إذن أيها المكان - الذي أمني النفس بزيارته في كل مرة أذهب فيها لولايتي وفي كل مرة أحجم عن فعل ذلك- ألهذا إذن تزورني أنت في منامي كحلم يضوع حنينا وحسرة؟