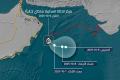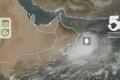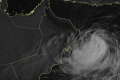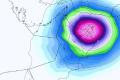رحاب أبو هوشر
تتعرَّض الصداقة -المفردة والمعنى- لضرر بالغ في حياتنا الافتراضية، ناهيك عن ابتذالها في الواقع، وافتقاد فضاءاتها وقيمها إلى حد كبير. ربما أن مصمِّمي مواقع التواصل الاجتماعي، استخدموا كلمتي "صداقة وصديق" كنوع من المجاز، لعلاقة إلكترونية ستنشأ، فحواها التعارف والتبادل والتواصل الاجتماعي، ولم يكن في حسبانهم أنَّ كثيرين يخلطون مسبقا بين مستويات العلاقات، وخلطهم يعني غياب المفهوم وجديته، يميعونها لأنهم لا يعنونها، فكل شخص يعرفونه يطلقون عليه وصف صديق، سواء كان شخصا التقوا به للمرة الأولى، أو آخر حادثوه صدفة لساعة أو ساعتين، أو زميلا جمعتهم به مقتضيات العمل وحسب! ضغطة من أحدهم بالموافقة على إضافة "صديق" ستعني له تحقق الصداقة، وعلى الصديق أن يستجيب للتطفل واقتحام الخصوصية، واستهلاك الكلمة مئات المرات في دردشات عامة لا تمت للصداقة بصلة، مع ألف أو خمسة آلاف صديق! يحدث أحيانا أن تتطوَّر "صداقات" إلكترونية، لعلاقات واقعية حية، ولكنها حالات نادرة، وقلتها تكرس افتراضية تلك الصداقات ولا تؤكدها.
معارف كُثر، ما يقترحه الواقع والافتراض، وقلة من الأصدقاء. هذا منطق العلاقات الإنسانية، فلا يمكن لأحدنا تكوين علاقة صداقة -بما تعنيه من تقارب نفسي وانسجام الفكر والمزاج- مع عدد كبير من البشر، بينما يمكن بسهولة للإنسان -الاجتماعي- بتكوينه وحاجاته، أن يُقيم عشرات العلاقات العامة مع محيطه.
الصداقة تقتضي قدرا يُقرُّ به الطرفان من التناغم، ومن عيش تفاصيل مشتركة، يتم اختبار العلاقة من خلالها، ومدى حقيقية هذه الصداقة ومتانتها وصدقيتها. كلما مضت بنا السنون، تناقص عدد الأصدقاء -لا تفلح مواقع التواصل الإلكترونية في زيادتها عادة- هذه إحدى خبرات الحياة المشتركة لمعظمنا، والتي لا ندركها إلا بعد أن نقف على مسافة معقولة من بداية وعينا بالصداقة.
نستغربُ من كمِّ أصدقاء الطفولة، حتى إنه كان بإمكان الواحد منا -سواء كنا صبية أو فتيات- أن نعد كل أطفال الحي بصفتهم أصدقاء، نقضي اليوم معهم باللعب والشقاوات الصغيرة. وفي المراحل الدراسية، تدخل صداقاتنا مرحلة الأطر، ولكنها تبقى في إطارها الواسع، فكل منا لديه مجموعة كبيرة أيضا من الأصدقاء، يتشارك وإياهم هموم الدراسة والتفاصيل الشخصية، ثم تبدأ المسبحة بالانفراط فور التخرج وبداية المرحلة العملية، عندها تكون شخصياتنا في طور التبلور والاكتمال، وكذلك معالم الطرق التي سيسلكها كل منا سعيا نحو المستقبل.
نتغيَّر نحن، أو أصدقاؤنا، باختلاف الأهداف والاتجاهات، أو بتغير الظروف ذاتها، إضافة إلى الاختبار المستمر بحكم التجربة، لما يتطوَّر ويتبدل في علاقتنا مع ذواتنا ومع العالم، أو بحكم الخيبات والخسارات. ومن كان حميما في مراحل سابقة، قد يذهب عنا بعيداً، أو ربما نحن من نتجاوز أصدقاء بتجاوزنا لمرحلة كانوا جزءا منها. ولا يتبقى لنا من صداقات عمرنا الفتي إلا العدد القليل، والقليل جدا.
ورَغْم الافتراق، فإنَّنا كثيرا ما نظل مشدودين بالحنين إلى تلك الصداقات، ويعترينا الفرح إذا ما التقينا أحد الأصدقاء القدامى، نذهبُ معه في الحديث إلى أيام يحسبها الحنين أجمل، ونفتح الأبواب على التذكر، نعدد أسماء أصدقاء كانوا، ونستقصي أحوالهم، وقد يسرد الصديق حادثة سقطت تماما من الذاكرة، ونفاجأ بالنسيان، وبعجزنا عن التذكر، عندها نعي ثقل الزمن الذي عبرنا دون أن ندرك فعله، ونتشبث بالصديق الذي تستيقظ الذكريات معه، وتستعيد الذاكرة حيويتها. مع هذا الصديق نقيم لبعض الوقت في الطفولة وعنفوان الصبا، نراوغ الزمن الخاطف.
وكَمْ تُدهشنا الصداقات المعمِّرة القائمة بين بعض المسنين، متانتها وحميميتها في الوقت نفسه، ونعجب لتكرارهم نفس القصص والحكايات عن أيامهم العتيقة، دون أن يشعروا بالملل. إنهم يفعلون ذلك باتفاق مُضمر، لتنبيه ذاكرتهم وتنشيطها بالحديث والتداعي، حتى لا يقعوا في فخ النسيان. إنهم يستذكرون بلا توقف، ليمتلكوا القدرة على الاستمرار، في حاضر يقفون على هامشه، ويبدو غريبا عنهم. الماضي صار مكانهم الأليف.
وفي أحوال أخرى، يشيح بعضنا بوجوههم عن صديق قديم، ويلوذون بالهرب من أمامه، ولو كان بإمكانهم لقاموا بتهشيم صورتهم التي يرونها في وجهه، إن كانوا غير مُتصالحين مع ذواتهم، ومع الزمن الزاحف على الأعمار قبل الوجوه، يدفعهم إلى ذلك الخوف من بصمات الزمن التي يرونها في تبدل الملامح للآخر-الصديق، فيبدأون بتحسس وجوههم، وتفحص التغضنات التي تركتها السنين على الجبين، في مرآة خارجة من ماض غير قابل للنسيان، لم تكن سوى ذلك الصديق. أو لعلها التجارب المريرة، والبؤس والألم الذي يلف مرحلة من العمر، هو ما يجعله يبذل الجهد المضني لإسقاط تلك المرحلة، ومحو الأسماء التي ترد فيها، لا سيما أسماء الأصدقاء.
... الصداقة أنبل العلاقات الإنسانية وأكثرها جدية وعمقا وأثرا، إنها تاريخ وذاكرة أيضا، ولا تعيش في شاشات الافتراض أو بين معارف فقط.